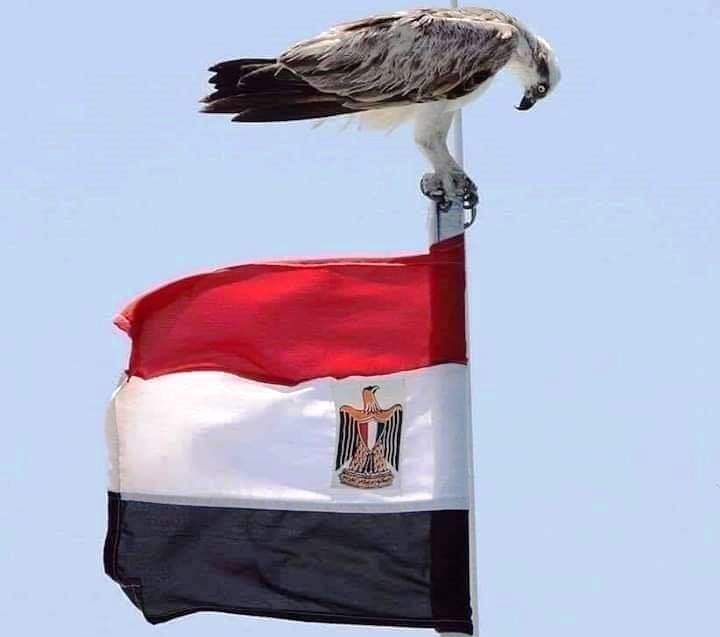
الجمهورية الجديدة … تعاظم أدوات “القوة المصرية الشاملة”
في مناسبات عدة، جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكر مبدأ “القوة الشاملة”، وذلك في معرض تأكيده على أن الدولة المصرية اتخذت نهجا استراتيجياً مدروساً بدقة في التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها.
الناتج الإجمالي لهذه القوة كان هو السبب الرئيسي في القدرات الميدانية والسياسية التي تحصلت عليها الدولة المصرية مؤخراً على المستويين الإقليمي والدولي، وسمح للقاهرة بأن تبسط أذرع التنمية ورأب الصدع في كافة أنحاء الإقليم، من سوريا والعراق شرقاً، إلى ليبيا وتونس غرباً، ومن اليونان وقبرص شمالاً، وحتى ما بعد منابع نهر النيل جنوبا.
صيانة الأمن القومي المصري “خاصة” والعربي “عامة” كان من أهم أهداف السعي المصري لتنمية وتعزيز القوة الشاملة، كي تكون القاهرة ليست فقط قادرة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، بل قادرة أيضاً على استغلال فائض القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية من أجل دعم تنمية قدراتها وإمكانياتها الذاتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي نفس الوقت تعزيز “تموضع” القاهرة في المحيط الإقليمي والدولي، واستغلال هذا “التموضع” من أجل تأمين المجال الحيوي المصري، وإيقاف اية محاولات خارجية لتهديده، وهي استراتيجية تواكب المتغيرات التي حدثت في المشهد الدولي عقب الحرب الباردة، حيث بات حفظ الأمن القومي لأي دولة، رهناً بالتحسن المتوازي في حالة جبهتيها الداخلية والخارجية، بحيث تتم صيانة السلم الأهلي وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل متواز ومكافئ للتقدم الذي يتم إحرازه دبلوماسياً وسياسياً على المستوى الخارجي.
تركيز “الجمهورية المصرية الجديدة” فيما يتعلق بالقوة الشاملة كان متعدد الاتجاهات، ما بين تحسين حالة “الكتلة الحيوية الحرجة” المتمثلة بشكل أساسي في السكان والحالة الصحية والاجتماعية لهم، وبين إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل حفظ وتنمية الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنى تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل، وطرق استغلالها وبين استعادة القوة السياسية للجمهورية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وبين مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية، وتنمية وتعزيز وسائط القوة العسكرية المتوفرة لدى مصر بالشكل الذي يسمح لها بفرض معادلة إقليمية للردع.
القوة الأمنية والعسكرية … تنمية وتطوير للمكافحة والردع

كان الملف الأمني والعسكري هو التحدي الأقرب والأكثر إلحاحاً أمام صانع القرار المصري خلال السنوات العشر الماضية، حيث نشأت عقب يناير 2011، مجموعة من التحديات الأمنية غير المتماثلة، التي مثلت تهديدًا مباشرًا للدولة المصرية، وكان في مقدمتها ظاهرة الإرهاب التي زادت حدتها عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013. على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2014 اتخذت مصر على المستويين الأمني والعسكري، كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمحاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها من جذورها، وترافقت هذه الإجراءات مع توجهات شاملة من جانب الدولة المصرية، لإعادة تقييم أوضاع جهاز الشرطة بكل مستوياته وأذرعه، وبدء خطة منهجية لتحديثه وتطوير آليات عمله ومستوى تجهيزه وتسليحه، وهو نفس ما تم اتباعه فيما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.
وجد جهاز الشرطة المصرية عقب يناير 2011 نفسه أمام استحقاقين أساسيين، الأول هو استعادة الأمن والاستقرار في شوارع ومدن الجمهورية، والثاني يتمثل في استعادة تماسك وثبات جهاز الشرطة على مستوى الأفراد والمؤسسات، بعد أن تأثر بشكل كبير بأحداث يناير وما تلاها من ضغوط سياسة وميدانية. فقد كان الموقف الأمني على الأرض متدهوراً بشكل دائم منذ الثامن والعشرين من يناير 2011، الذي شهد حرق أغلب أقسام الشرطة في كافة محافظات الجمهورية، ما أدى إلى انهيار جهاز الشرطة، واقتحام السجون التي تضم قيادات جماعة الإخوان والمسجونين الجنائيين وتهريبهم، واقتحام وسرقة ونهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وهذا كله أدى إلى دخول مصر في خضم حالة كبيرة من الانفلات الأمني نتيجة غياب جهاز الشرطة عن المشهد، وتولت القوات المسلحة مهام حفظ الأمن وذلك وسط توترات سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
الأوضاع الأمنية بشكل عام في كامل ربوع الجمهورية كانت في تدهور مستمر، فقد أشار تقرير لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، إلى أن عام 2011 سجل أعلى معدلات الجريمة في مصر، إذ سجلت جرائم القتل أعلى نسبة بمعدل 2774 حادث قتل على مستوى الجمهورية، أما حوادث السرقة بالإكراه فسجلت أعلى عدد وهو 3312 حادثًا، وسجلت جرائم الخطف 2229 حادثًا، وبلغت سرقة السيارات أعلى معدل في تاريخ مصر مسجلة 17800 حادث سرقة سيارة على مستوى المحافظات، أما حوادث السطو المسلح على الشركات والسيارات المحملة بالبضائع على الطرق فبلغ عددها 495 حادثًا، وارتفعت جرائم سرقات المنازل إلى أكثر من 11 ألف حادث، مقارنة بحوالي 7 آلاف حادث عام 2010، وهو الوضع الذي استمر بنفس الوتيرة خلال عام 2012.
في سيناء أخذت التهديدات الأمنية شكلا مختلفا عما هو موجود في وادي النيل، فبعد أن أسفرت الجهود الأمنية والضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية في سيناء بعد التفجيرات الإرهابية في شرم الشيخ ودهب عامي 2005 و2006 عن إخماد كافة الأنشطة الإرهابية بسيناء والسيطرة عليها، جاءت أحداث يناير 2011 بمثابة قبلة الحياة لتلك الجماعات التي استأنفت نشاطها من جديد، حيث عبرت عناصر إرهابية قادمة من الخارج عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى داخل شمال سيناء وأشاعت فيها الفوضى، واستهدفت أقسام الشرطة والكمائن الأمنية وخطفت عددًا من رجال الشرطة. وساهمت طبيعة سيناء في تشكيل ونشاط بعض تنظيمات السلفية الجهادية التي بدأت في استهداف خط الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل في 5 فبراير 2011، ثم القيام بعدة عمليات إرهابية ضد عدد من المقرات الأمنية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
تفاقمت هذه الأوضاع بشكل “دراماتيكي” منتصف عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو -التي انتفض فيها الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان- حيث شهدت مصر موجة إرهابية هي الأعنف على الإطلاق، واستهدفت الجماعة من خلال المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها بشكل يومي أقسام الشرطة، وزرع عناصر الجماعة عددا كبيرا من العبوات الناسفة في عدد من الأماكن الحيوية بهدف ترويع المواطنين وإسقاط ضحايا منهم. طالت العمليات الإرهابية التي تمت في هذه الفترة البنية التحتية في أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد، إذ تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عالٍ، و510 أكشاك ومحول كهرباء على مستوى الجمهورية، بخسائر بلغت أكثر من ملياري جنيه خلال عامي 2014 و2015 فقط، وذلك بخلاف الخسائر الفادحة الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء، بجانب محاولات استهداف عدد من البنوك الأجنبية بالجيزة، بالإضافة إلى حرق وتدمير قرابة 75 كنيسة.
يضاف إلى ذلك ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية التي نبعت من رحم جماعة الإخوان، ومنها (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) وعدد من الخلايا العنقودية الأخرى، التي نفذت مجموعة من العمليات الإرهابية، شملت عدد من محاولات الاغتيال، منها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق.
تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية عام 2014، وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس وأسفر عن استشهاد 30 جندي وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين. أما عام 2015 فقد شهد طفرة في عدد العمليات الإرهابية على الساحة المصرية ووصل عددها إلى 594 عملية.
بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه عام 2014، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ خطة كبيرة وشاملة تشمل العديد من الإصلاحات والإجراءات المختلفة، بهدف كفالة وتحقيق أمن المواطن، وإعادة هيبة الدولة وسيطرتها على كافة أرجاء الوطن، وكذا إعادة الثقة للأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب من خلال منظور شامل متعدد الجوانب، مع الحرص قدر الإمكان على تجنب الآثار الجانبية التي تمس المواطنين في مناطق المواجهة. وقد ارتكزت جهود الشرطة المصرية في مساعيها لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وهي الجهود التي بدأت فعلياً عام 2015، على محورين أساسيين:
● المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
● المحور الثاني: يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.
على المستوى الميداني، وبناء على الاستراتيجية السالف ذكرها، شرعت وحدات الشرطة المصرية المختلفة، في مساندة القوات المسلحة خلال سلسلة العمليات العسكرية والأمنية التي بدأت في سيناء، بداية من العمليتين العسكريتين “نسر-1” و”نسر-2″، والحملة العسكرية الموسعة التي تمت في سبتمبر 2013، وشملت سيناء وأغلب المحافظات المصرية، وتم خلالها القضاء على عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية، والقبض على عدد من العناصر شديدة الخطورة. ثم شاركت وحدات الشرطة في العمليات الميدانية المترتبة على القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014، بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق في سيناء، ومنها فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح والبدء في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1 كم من الشريط الحدودي في مدينة رفح بطول 14 كم لفرض السيطرة على تلك المنطقة التي يوجد بها الكثير من الأنفاق، وقد دفعت وزارة الداخلية المصرية في ذلك التوقيت، بأعداد كبيرة من عناصر العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بالوزارة من أجل مساندة وحدات الجيش المتواجدة شمالي سيناء.
تلت العمليات السالف ذكرها، المرحلة الأولى من العملية العسكرية والأمنية الشاملة “حق الشهيد”، التي تم إطلاقها في السابع من سبتمبر 2015، لمواجهة الإرهاب بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش)، وتلتها المرحلة الثانية في الثالث من يناير 2016، وقد شاركت وحدات العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي في الشرطة المصرية بشكل مكثف في كلا العمليتين، اللتين تم خلالهما القضاء الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية من أوكار وبؤر ومخازن وملاجئ، وتصفية أغلب قيادات الصف الأول والثاني لهذه التنظيمات، كما ساهمت التعزيزات الأمنية التي تدفقت بشكل دائم على مدن شمال سيناء، إلى تحسين الأوضاع الأمنية الداخلية في هذا المدن، وتسهيل حياة المواطنين بعد أن تم تحجيم النشاط الإرهابي في هذه المناطق بشكل كبير.
لم تقتصر الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب على سيناء فقط، وإنما شملت كافة محافظات الجمهورية، إذ قامت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل، وضبط عدد كبير من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها الجماعة لشن الهجمات، وكان آخرها تصفية الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، والتي كانت تخطط لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية ضد الإخوة الأقباط. أسفرت الجهود السالف ذكرها، عن تمكن كافة إدارات وفروع الشرطة المصرية مطلع عام 2016، من استعادة زمام المبادرة في الحرب ضد الإرهاب، وكان مصرع القيادي الإخواني “محمد كمال” الذي كان يتولى إدارة النشاط المسلح لجماعة الإخوان، عام 2016 في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية خلال محاولة القبض عليه، هو أول ثمار استعادة جهاز الشرطة لتماسكه.
وتمثل هذا بشكل واضح في التراجع التدريجي في عدد العمليات الإرهابية منذ ذلك التوقيت، إذ تراجعت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وشهد عام 2018 ثماني عمليات فقط، أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى لاستشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة، بينما شهد عام 2020 انخفاضًا كبيرًا للعمليات الإرهابية في سيناء، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك، ولم تشهد محافظات القاهرة والوادي والدلتا في هذا العام وحتى اللحظة المعاشة أية عمليات إرهابية، وهو ما يؤكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية تؤتي ثمارها، ومثلت هذه النتيجة الخطوة الأولى في تقوية جانب من جوانب “القوة الشاملة” وهو القدرة الأمنية في مواجهة التهديدات الداخلية.
التحسن في مجال مكافحة الإرهاب، واكبه نجاح أخر في مواجهة الجرائم الجنائية بكافة أشكالها، إذ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين. كما قامت الوزارة بوضع آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.
نتيجة لهذه الجهود انخفضت معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية بنسبة 17% في عام 2020 مقارنة بعام 2018، وقد نجحت الدولة المصرية في رفع معدلات الأداء الشرطية من خلال حزمة من البرامج الأمنية، وأصبحت المدن المصرية في صدارة التصنيفات المتعلقة بأمن المدن، ووفقاً لمؤشر جالوب للقانون والنظام لعام 2018، والصادر عن مؤسسة (جالوب) الدولية المتخصصة باستطلاعات الرأي، يشعر المواطنين في مصر بمستوى عال من الأمن والاستقرار، ووصلت مصر وفقاً لاستطلاع الرأي الذي شمل (142) دولة على المركز الـ (16) لتتساوى مع الدنمارك وسلوفينيا ولوكسمبورج والنمسا والصين وهولندا من حيث شعور المواطنين بالثقة في الأجهزة الشرطية وإجراءات تطبيق القانون عبر المؤسسة الأمنية، وبهذه المرتبة فقد تفوقت الشرطة المصرية على نظيراتها في عدة دول مثل بريطانيا وإسبانيا واليابان والولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وروسيا.
بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن، بدأت الدولة المصرية مبكراً في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك عبر العديد من الإجراءات منها إعادة هيكلة جهاز “مباحث أمن الدولة”، وإنتاج جهاز جديد لأداء الدور ذاته باسم جهاز “الامن الوطني”، كذلك إصدار الوزارة لـ “مدونة قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي”، وصولاً إلى إعادة هيكلة قطاع “مكافحة المخدرات”، ليصبح قطاعاً لـ “مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة”، وتحويله الى قطاع يحوي عدد من الإدارات مثل إدارة “مكافحة المخدرات” وإدارة “مكافحة الأسلحة غير المرخصة”، بالإضافة لإدارة “مكافحة الهجرة غير الشرعية”. كما رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة الخدمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية. وقد تمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة. كذلك استصدار قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، رقم 82 لسنة 2016، لضمان المواجهة الفعالة لتلك الظاهرة.
كذلك تبنت وزارة الداخلية المصرية جهود لتطوير آليات تقديم الخدمات للجماهير، وهو ما اتضح من خلال عدد كبير من الإجراءات الميدانية، منها:
● الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 100 قسم شرطة خلال عام 2020، روعي في تصميمها أن تكون ذات شكل عصري وفقًا لنموذج موحد، وروعي تطوير بعض الأقسام بما يتناسب مع البيئة المعمارية والأثرية المحيطة لبعض المحافظات. وتم الانتهاء من رفع كفاءة 160 مقرًا للأحوال المدنية، وتواصل الوزارة العمل في تطوير باقي المقرات من الناحية الإنشائية والتكنولوجية والارتقاء بمنظومة العمل بها.
● إنشاء وتجميع بعض الكيانات الشرطية بمواقع خارج نطاق الكثافات العالية لتحقيق السيولة المرورية، مثل مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد، والذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني بما يتضمنه من تجهيزات فنية ولوجستية وتكنولوجية.
● افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة عام 2016، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.
● إنشاء مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية في عام 2018، وهو مزود بأحدث أجهزة الاتصال، ومتصل بكل مديريات الأمن وقواعد بياناتها على مستوى الجمهورية.
● تدشين المقر الجديد لـ “إدارة الجوازات والهجرة” لتيسير الخدمات والارتقاء بها الى مستوى قياسي، كذلك افتتاح مجموعة من “وحدات المرور المتنقلة” للتيسير على المواطنين، بالإضافة الى إنشاء “إدارة عامة للعمليات بقطاع الأمن” للتنسيق ومتابعة العمليات الأمنية، لضمان تحقيق أقصى درجات التناغم والتكامل بين عمليات مكافحة الجرائم لتعظيم العائد وتوفير الموارد.
● بدأت الوزارة في خطة لميكنة الخدمات الشرطية، وإدخال التطبيقات الذكية في تقديم خدماتها للمواطنين، لضمان تقديم الخدمة بصورة شفافة وعادلة لجميع المواطنين، وتحييد العنصر البشري عن تلك العمليات قدر الإمكان؛ لاستثماره بشكل أفضل في مواضع الخدمات التي تتطلب تدخل بشري أكبر، خاصة في ظل ظروف استثنائية مثل وباء “كوفيد-19″، مثل خدمات السجلات المدنية والجوازات والمرور، مما يساعد على دقة الأداء ودقة الفحص إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، حيث تم إنشاء ٥٠ وحدة سجل مدنى جديدة مع تطوير شامل لـ٨٠ مقرا للأحوال المدنية من حيث الإنشاءات والأجهزة وأماكن الانتظار كمرحلة أولى. كما جرى تدشين منظومة جديدة من الماكينات للحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى)، وكذا تم الانتهاء من ميكنة 175 وحدة مرور، و229 نيابة مرور، و11 منفذ جمركي، إلى جانب إتاحة 3 خدمات لنيابات المرور على البوابة والمحمول، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور في 50 وحدة مرورية.
● كما أنشأت وزارة الداخلية منصة موحدة للتحقق الرقمي، يستطيع المواطن من خلالها التسجيل للحصول على الخدمات الجماهيرية في مجالات: الأحوال المدنية، والمرور، وتصاريح العمل، والأدلة الجنائية، والجوازات والهجرة والجنسية. وامتدت الخدمات لتلقي طلبات الزيارات لنزلاء السجون عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بالإضافة لطلبات الحج والإخطار ببيانات العين المؤجرة.
● يواصل قطاع الشرطة المتخصصة بتزويد الشوارع والميادين الرئيسية بكاميرات مراقبة حديثة لرصد المعوقات المرورية بالإضافة إلى تركيب إشارات إلكترونية مزودة بكاميرات دقيقة لتنظيم حركة المرور ورصد المخالفين إلكترونيًا، كما تواصل الأجهزة المعنية تركيب أجهزة رادار حديثة تتمكن من رصد المخالفين للسرعة القانونية حفاظا على حياة المواطنين.

على المستوى العسكري، كان الجيش المصري جنباً إلى جنب مع الشرطة المدنية منذ عام 2011 للتصدي للمخاطر الإرهابية شمالي سيناء، لكن كانت هناك مهمة عاجلة اخرى وجد صانع القرار نفسه أمامها عام 2014، وهي التحديث العاجل و”الفعال” لتحديث كافة أفرع الجيش المصري – خاصة القوات البحرية – نظراً لوجود بعض القصور في هذا الصدد، بما يمنع الدولة المصرية من ممارسة دورها الإقليمي والدولي المنشود، الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى قوة ردع تسمح للقاهرة بصيانة مقدراتها السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التهديدات التي طرأت على المحيط الإقليمي لمصر خاصة في الاتجاه الغربي والجنوبي، وكذا في شرق المتوسط.
خلال الأعوام الخمسة الماضية تطورت بشكل كبير الرؤية العسكرية للقيادة المصرية على مستوى التكتيك والاستراتيجيات، فبدأ الجيش المصري بشكل عاجل عام 2014 خطة مكثفة لتطوير تسليحه على كافة المستويات، بشكل يضمن له قدرة الردع من جهة، وقدرة تنفيذ عمليات هجومية خارج الحدود، مع الوضع في الاعتبار تطوير قوات خفيفة الحركة وثقيلة التسليح مثل قوات الرد السريع، وتدريبها على مواجهة المخاطر العسكري غير النمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية في سيناء. هذه الخطة تمت في ضوء تطورات الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تواجه صانع القرار المصري. وقد وراعت القيادة المصرية في هذه الخطة توسيع مبدأ “تنويع مصادر التسليح” و”طلب التصنيع المحلى ونقل التقنيات” في كل صفقة إن أمكن. وفي هذا تأكيد على التوجه الجديد للقيادة في ما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها في مصر من جهة، وتنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأي دولة في ان تتحكم في نوعية وكم ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية.
تكونت خطة التحديث هذه من خمس نقاط أساسية هي تحديث القوات الجوية، تحديث القوات البحرية، تحديث القوات البرية والدفاع الجوي، تحديث البنية التحتية العسكرية، المناورات والتدريبات العسكرية:
1- تحديث القوات البرية والدفاع الجوي: تعاقدت قوات الدفاع الجوي المصري خلال السنوات الماضية على المنظومات الآتية :
أ- نظام الدفاع الجوي الروسي قصير المدى “تور أم- تو أي” الفعال ضد الصواريخ الجوالة ومُختلف المقذوفات والذخائر الجوية وكافة الوسائط الجوية الأخرى.
ب- نظام الدفاع الجوي الروسي متوسط المدى “بوك أم – تو أي”، الفعال بشكل خاص ضد الصواريخ البالستيكية والصواريخ الجوالة والصواريخ المضادة للرادار ومختلف أنواع الطائرات والمروحيات.
ج- نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى IRIS-T SLM، القادر على التعامل مع معظم التهديدات الجوية.
د- رادار الإنذار المبكر البريطاني Commaner SL، ويصل مداه الأقصى الى 450 كيلو متر .
ه- أربعة بطاريات من نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى”أس300- في أم”، الذي يعد من أهم الإضافات النوعية للدفاع الجوي المصري، حيث يصل مداه الأقصى الى 250 كيلو متر، وفعال ضد كافة التهديدات الجوية، وهو الذراع الطولى حالياً في تشكيلات الدفاع الجوي المصري. وانضم اليه مؤخراً إضافة نوعية مهمة هي رادار الإنذار المبكر الروسي Rezonans-NE، الذي يمتلك القدرة على رصد الأهداف الجوية منخفضة البصمة الرادارية وكافة الأجسام الطائرة بما فيها الصواريخ الفوق صوتية ويصل مداه الأقصى إلى 1100 كم، وقد أنضم إلى رادار إنذار مبكر روسي آخر هو الرادار ثلاثي الأبعاد Protivnik-GE، ويصل مدى تغطيته الى 400 كم.
كما دخل الى الخدمة في تسليح الدفاع الجوي المصري، رادار الإنذار المبكر المصري الصنع ثنائي الابعاد ESR-32A، ويصل مداه إلى 250 كم، ومن مميزاته أنه يصلح للاستخدام المدني أيضا لمراقبة وتوجيه حركة الملاحة الجوية. ويضاف هذا إلى جانب أعمال تطوير وتحديث للمنظومات الموجودة فعلياً في ترسانة الدفاع الجوي المصري.
و- وقد وقعت القوات البحرية المصرية مؤخراً عقداً مع شركة (رايثيون) للصناعات الدفاعية والصاروخية، القوات البحرية المصرية، بما مجموعه مائة وثمانية وستين صاروخ مضاد للطائرات، من نوع (RIM-116C) وتحديداً الجيل الثاني منه (Block 2)، لتسليح الزوارق الصاروخية الأمريكية الصنع (أمباسادور)، التي تمتلك منها البحرية المصرية أربعة زوارق.

تحديث القوات البحرية المصرية: وضعت البحرية المصرية خلال عام 2011 خطة عاجلة لتحديث تسليحها على مستوى الكم والنوع، وذلك لأسبابٍ عديدةٍ تأتي على رأسها التهديدات الإقليمية الجدية المتعلّقة باستخراج الغاز الطبيعي شرقي المتوسّط. هذه الخطة ركَّزت على زيادة أعداد الفرقاطات وزوارق الصواريخ والغوّاصات، والحصول على سفن للإنزال البرمائي، ما يوفّر للبحرية المصرية قدرات كبيرة على شن عمليات خارج نطاق السواحل المصرية، كذلك روعيَ في هذه الخطة تقسيم القوّة البحرية المصرية إلى قسمين، الأول باسم “أسطول البحر المتوسّط”، والثاني باسم “أسطول البحر الأحمر”، وكذا تجهيز البنية التحتية لتكوين لاحق لقسم جديد في القوات البحرية المصرية وهو قسم “طيران البحرية”. كانت ضربة البداية في هذه الخطة عام 2012، حين تعاقدت البحرية المصرية مع ألمانيا على شراء غوّاصتي ديزل من الفئة “تايب 209/1400″، تلتهما اثنتان من نفس الفئة عام 2014، ويتسلّح هذا النوع من الغوّاصات بطوربيدات من عيار 533 ملم وصواريخ هاربون المُضادّة للسفن، وقد شكّلت هذه الصفقة إضافة نوعية إلى البحرية المصرية على مستوى الكمّ والنوع.
تعاقدت البحرية المصرية بعد ذلك عام 2014، مع فرنسا لشراء أربعة طرّادات صاروخية من الفئة “جويند-2500″، في صفقة تعدّت قيمتها مليار يورو، وتتميّز هذه الفئة من الطرّادات بتسليح ممتاز يضع في الحسبان كافة أنواع التهديدات، حيث تتسلّح بمدافع من عياري 20 و76 ملم، بجانب 16 خلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نوع “ميكا”، وثمانية صواريخ مُضادّة للسفن من نوع “أكسوسيت”، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المُضادّة للغوّاصات.
عام 2015 كان عاماً ذهبياً في سياق هذه الخطة، ففي يوليو 2015، وقّعت مصر مع فرنسا عقداً تسلّمت البحرية المصرية بموجبه فرقاطة مُتعدّدة المهام من الفئة “فريم”، مسلّحة بالنسخة الثالثة من صواريخ “أكسوسيت” المُضادّة للقطع البحرية، وقاذفي طوربيدات من عيار 323 ملم، بجانب صواريخ “أستر 15” للدفاع الجوي، ومدافع من عياري 20 و76 ملم. تسلّمت البحرية المصرية في أغسطس من نفس العام زورق الصواريخ الهجومي من الفئة “مولينيا بي-32” روسي الصنع كهدية، وهو إضافة نوعية أيضاً حيث يتسلّح بأربع منصّات لإطلاق صواريخ “موسكيت” المُضادَة للسفن، بجانب مدافع من عياري 30 و76 ملم وصواريخ “سام-18” المُضادّة للطائرات.
الإضافة الأهم إلى الأسطول البحري المصري كانت خلال عام 2016، حين تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء سفينتي هجوم برمائي من الفئة “ميسترال” بقيمة وصلت إلى مليار دولار، لتكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة بالإضافة إلى الجزائر، التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية، التي أضافت إلى البحرية المصرية قدرات برمائية قتالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية، وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادراً على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنّف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق “الأنهار والسواحل” فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تنبع أهمية هذه الفئة من السفن في تعدّد المهام التي تستطيع القيام بها. تستطيع سفن هذه الفئة التي تبلغ إزاحتها 22 ألف طن العمل كمراكز قيادة وسيطرة عائمة نظراً لإمكانية استيعابها لنحو مائتي عنصر لإشغال مساحة مركز القيادة على سطحها والتي تبلغ 850 متراً تحتوي على منظومات للقيادة والتحكّم، وأنظمة للاتصال بالأقمار الصناعية، وأنظمة للمعلومات البحرية والبحث والتوجيه الكهروبصري والتتبّع بالحرارة، بجانب مجموعة من الرادارات ووسائط الإعاقة والتشويش للمعاونة والرصد. من أهم الأدوار القتالية التي تستطيع سفن هذه الفئة تنفيذها هو العمليات البرمائية الهجومية. تمتلك الميسترال مساحة تتعدّى 2500 متر مقسّمة بشكل حظائر لتخزين المركبات والعتاد الحربي تستطيع استيعاب حتى 70 عربة مدرّعة أو ما يقرب من 45 دبابة قتال رئيسية. ضمن هذه المساحة يتواجد قسم للأفراد يستطيع استيعاب ما بين 450 إلى 700 جندي حسب طبيعة المهمة ومداها. يتم إنزال هذه القوات إلى الشاطئ من خلال الرصيف الداخلي أسفل بَدَن السفينة والذي يستطيع استيعاب أربع مركبات للإنزال.
العمليات الجوية تعدّ من المهام الحيوية التي تنفّذها سفن الميسترال، فهي تستطيع حمل 16 مروحية ثقيلة أو 35 مروحية خفيفة في مساحة تخزين تقع أسفل سطح السفينة مباشرة. يحتوي السطح على ست نقاط للهبوط تستطيع إحداها استيعاب هبوط مروحيات النقل الثقيل ويربط بين السطح ومنطقة الحظائر وورش الصيانة والإصلاح مصعدان لنقل المروحيات في ما بينهما. للميسترال أيضاً دور مهم يتعلّق بعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث حيث يتواجد على متنها مستشفى تتعدّى مساحته 700 متر مربع يتضمّن 20 غرفة وأقساماً متنوّعة وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز بجانب 70 سريراً طبياً مضافاً إليها حوالى 50 سريراً آخر يتم تخزينها في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ. بامتلاك الميسترال أصبحت مصر الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تمتلك حاملات للمروحيات أو الطائرات.
عام 2017 انضم إلى الأسطول المصري طرّاد الدورية الساحلية من الفئة “بوهانج”، الذي تسلّمته مصر كهدية من كوريا الجنوبية أواخر عام 2017، كما تسلّمت البحرية المصرية من إيطاليا ثلاث غوّاصات من نوع “بلوتو بلس” لمكافحة الألغام البحرية. الأشهر الماضية دخلت عدة قطع أساسية ومهمة في تسليح البحرية المصرية، منها فرقاطتين متعددتي المهام من النسخة الإيطالية من الفئة “فريم”، دخلتا الخدمة في ديسمبر 2020 وأبريل 2021. وسوف تنضم لهذه الفرقاطات، أربعة فرقاطات ألمانية المنشأ من نوع “ميكو-2000″، بدأت بالفعل عمليات تصنيع الفرقاطة الأولى منها في الإسكندرية، وذلك بموجب عقد وقعته مصر مؤخراً مع شركة “تيسين كروب” الألمانية، لتتعزز بذلك قوة الفرقاطات الموجودة لدى البحرية المصرية، وتتزايد بالتالي القدرات القتالية المتوفرة لصانع القرار المصري، سواء على مستوى الردع او مستوى المواجهة الميدانية، خاصة شرقي المتوسط.

تحديث القوات الجوية المصرية: نظراً لأنه وحتى وقت قريب كانت مقاتلات “أف-16” الأمريكية الصنع هي المقاتلة الأساسية لسلاح الجو المصري، تعاقدت مصر بصورة عاجلة عام 2015 على شراء 24 مقاتلة فرنسية الصنع من نوع “رافال”، ليس فقط لأنها مقاتلات متفوقة وتوفر للقوات الجوية المصرية القدرة على شن عمليات جوية خارج الأجواء المصرية، لكن ايضاً بسبب أن مصر تضع دوماً في حسبانها احتمالات تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وما يتبعه ذلك من احتمالات إيقاف توريد قطع الغيار الخاصة بـ المقاتلات المصرية “كما حدث مع إيران أبان حربها مع العراق”، وقد تسلمت مصر جميع طائرات هذه الصفقة وأدخلتها الى الخدمة الفعلية، بل وتعاقدت مع فرنسا خلال الأسابيع الماضية على شراء 30 مقاتلة إضافية من هذا النوع المتفوق. فيما يتعلق بـ مقاتلات الأف 16، تسلمت مصر الدفعة الأخيرة من صفقة شراء 20 مقاتله من هذا النوع عام 2015. وفي نفس العام تعاقدت مصر على شراء 46 مقاتلة متعددة المهام روسية الصنع من نوع “ميج-29 ام2” معدلة خصيصاً حسب المتطلبات المصرية، تسلمتها مصر بشكل كامل.
التطور الأهم في تسليح سلاح الجو المصري تحقق بتعاقد مصر مع روسيا على شراء أعداد من مقاتلة التفوق الجوي “سوخوي 35 أس” نهاية العام الماضي، ويتوقع أن يبدأ تسلم أول دفعة منها منتصف العام المقبل. هذا النوع من المقاتلات يعد من أهم منجزات الصناعات العسكرية الروسية على مستوى الوسائط الجوية، وتتخصص في مهام فرض السيطرة الجوية، وتتميّز بقدرات هجومية فائقة خاصة في ما يتعلق بسرعة بزوايا الهجوم والمناورة، وظهرت للمرة الأولى عام 2007، ودخلت الخدمة للمرة الأولى في القوات الجوية الروسية منتصف عام 2014. تبلغ سرعتها القصوى ما بين 1400 و 2400 كيلو متر في الساعة حسب ارتفاع التحليق، وتستطيع الطيران بارتفاعات تصل إلى 18 كيلو متراً، ويتراوح مداها الإجمالي ما بين 1580 و3600 كيلو متر حسب الارتفاع والسرعة. تتميّز بتزوّدها برادار سلبي من الفئة “بيسا” يتيح لها مدى رصد أقصى يتراوح ما بين 150 إلى 350 كيلو متراً حسب نوع الهدف الذي يتم تتبّعه، كما يوفّر هذا الرادار للمقاتلة القدرة على تتبّع 30 هدفاً جوياً والاشتباك مع ثمانية أهداف منها في نفس الوقت، وتتبّع أربعة أهداف بحرية أو أرضية واستهداف هدفين منها في نفس الوقت، ويستطيع هذا الرادار رصد أحدث المقاتلات الأميركية وهي المقاتلة أف-35، “التي تمتلكها إسرائيل”، من مسافة تصل الى 50 كيلو متراً. من أهم مميزات هذه المقاتلة حمولتها التسليحية الثقيلة التي تصل إلى ثمانية أطنان.
بمجرد دخول هذا النوع من المقاتلات للخدمة في سلاح الجو المصري، سينضم إلى تشكيلة متنوّعة من المقاتلات مختلفة المنشأ التي تمتلكها القوات الجوية المصرية حالياً، مثل مقاتلات الميراج 2000 والرافال الفرنسية، ومقاتلات الميج 35 الروسية، ومقاتلات الأف 16 الأميركية. وهذا التنويع بالإضافة إلى كونه حيوياً جداً لضمان استمرار القوات الجوية في تأدية مهامها حتى ولو توتّرت علاقاتها ببعض بلدان المنشأ، يوفّر أيضاً القدرة لهذه القوات على تنفيذ كافة المهام الجوية، بما فيها فرض السيطرة الجوية والتصدّي للمقاتلات الحديثة المناظرة،
فيما يتعلق بالمروحيات والطائرات دون طيار، تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع “كا-52″، يتم تسليم آخر دفعاتها العام القادم. وتتفاوض مصر حالياً على النسخة البحرية منها للعمل على متن سفن الإنزال البرمائي من الفئة “ميسترال”. يضاف الى هذا النوع مروحية هجومية روسية أخرى تم التعاقد عليها وهي المروحيات القتالية “مي-24″، وقد ظهرت للمرة الأولي في مصر عام 2018. أما عن الطائرات دون طيار، فقد حصل سلاح الجو المصري عام 2016 على الطائرات الصينية الهجومية دون طيار “وينج لونج-1″، تبعها تعاقد مصر عام 2018 على النسخة الأحدث من هذا النوع والمسماة “وينج لونج-1دي”، وقد مثلت هذه الطائرات نقلة كبيرة في العمليات الجوية المصرية في سيناء، لأنها من جهة وفرت تكاليف استخدام المقاتلات في عمليات قصف الأهداف الإرهابية في سيناء، ومن ناحية اخرى وفرت قدرات هجومية جديدة لسلاح الجو المصري، في ظل توجه عالمي نحو التقنيات المسيرة.
فيما يتعلق بعمليات تحديث البنية التحتية العسكرية للجيش المصري، افتتح الرئيس المصري في يوليو 2017 قاعدة “محمد نجيب” العسكرية للتدريب العسكري بمدينة الحمام في محافظة مطروح، وهي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان. وحالياً تجري عمليات مكثفة لبناء ثلاثة قواعد بحرية جديدة، الأولى هي قاعدة رأس بناس في منطقة برنيس على البحر الأحمر جنوبي شرق البلاد، ويتم إنشاؤها بغرض ضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة تمركز إضافية للأسطول البحري الجنوبي بالإضافة الى قاعد سفاجا البحرية. القاعدة الثانية هي قاعدة شرق بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس على البحر المتوسط، بغرض توفير حماية إضافية للمنطقة الاقتصادية وميناء ومدينة شرق بورسعيد، إلى جانب تأمين الملاحة في الجزء الشمالي من قناة السويس، والسواحل الشمالية لشبه جزيرة سيناء المصرية حتى ميناء العريش. القاعدة الثالثة هي قاعدة جرجوب بمنطقة النجيلة غربي مطروح، وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الإقتصادية المُزمع إنشاؤها غرب مصر، والتي تتضمن ميناء جرجوب التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجستية، والمدينة الترفيهية العالمية. يتم هذا بالتزامن مع عمليات تطوير عدد من القواعد الجوية، مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكري في مطار برج العرب في الإسكندرية، و قاعدتي شرق وغرب القاهرة الجوية، قاعدة القطامية الجوية، مطار شرق العوينات، مطار العريش الدولي، مطار برنيس المجاور لقاعدة راس بناس الجوية.
على مستوى التصنيع العسكري، أولت القيادة المصرية اهتماما بالصناعات الحربية وتطويرها، وهذا كان واضحاً في معرض “أيديكس 2018” الذي تم عقده للمرة الأولي في القاهرة العام الماضي، وشهد عدد كبيراً من المنتجات العسكرية المصرية، والتي تستهدف من خلالها القاهرة ان تفتح ابواب لتصدير منتجاتها الى الخارج، وهو ما بدء يحدث فعلياً في أفريقيا ومنطقة الخليج. كما اهتمت القيادة خلال السنوات الماضية بالمناورات والتدريبات العسكرية سواء التي ينفذها الجيش داخلياً او المناورات المشتركة، وباتت هناك مناورات سنوية ثابتة مع دول مثل روسيا “حماة الصداقة”، اليونان وقبرص “ميدوزا”، وهذا يأتي في أطار علاقات تعاون عسكري واسعة النطاق تم عقدها مع روسيا واليونان.
الإصلاح الاقتصادي … حماية للكتلة السكانية وضمان لقوة الدولة المصرية
يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخصًا بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية. خلال عام 2014، ونتيجة لما مرت به مصر فيما بعد 2011، تفاقمت معدلات التضخم لتصبح في مستوى يتراوح بين 10% و11%، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، مما أدى الى زيادة كبيرة في معدل البطالة ليصبح ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 ملياراً و606 مليون جنيه، وبلغت نسبة العجز في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع %11.5 في السنة المالية السابقة.
لمعالجة هذا الوضع، تم خلال السنوات الماضية، البدء في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، من ضمنها إعادة توزيع الدعم كاستراتيجية أساسية، مضافاً إليها قرارات اقتصادية عاجلة ومهمة مثل قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإخضاعه لقوى العرض والطلب. مما أسفر عن نتائج ممتازة في العام التالي، حيث أنه بحلول نهاية أكتوبر 2017 حقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت 15.9 بالمائة لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها، فيما تراجعت الواردات 13.7 بالمائة، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.3 بالمائة منذ قرار التعويم عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وبلغت 16.3 مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن العام السابق.
خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح عام 2019، فقد احتلت مصر في هذا العام المرتبة الأولى شرق أوسطياً في معدلات النمو، وفقاً لبيانات الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 5,7%، وهذا يرجع الى انتهاء الحكومة بشكل كامل من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، والتوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة. يذكر هنا أن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8,3% في هذه الفترة مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، وبلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلى 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ معدل البطالة 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق، وارتفع إجمالي الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي الى 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، وتحسن أداء الجنيه المصري، مقابل الدولار بنسبة 16%، بعد أن وصل أواخر عام 2016 الى أضعف حالاته على الأطلاق أمام الدولار بسعر أقترب من 20 جنيه للدولار الواحد.
على مستوى الصناعة، شهدت الفترة الماضية نمواً واضحاً في أعداد المصانع الجديدة، حيث بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014 خطة لتنفيذ 45 مشروعا يخدم مجال الصناعة في مصر بتكلفة إجمالية 92 مليار جنيه، تشمل إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمعا ومنطقة اقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنع ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية. وقد تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 22 مشروع متنوع بإجمالي 498 مصنعا، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33٫04 مليار جنيه.
وجاء في مقدمة المشروعات التي تم الانتهاء منها، المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى بإجمالي تكلفة 2٫2 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1٫1 مليار جنيه، وإنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهى: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، و9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة، مما وفر نحو 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه. وقد ساهمت بشكل كبير التسهيلات التي تم توفيرها للمستثمرين في صدور 19٫5 ألف رخصة تشغيل لمصانع ومؤسسات صناعية منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية. وتم اتخاذ إجراءات أخرى في نفس الاتجاه منها وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات.
14- من أهم مصادر الدخل القومي لمصر هو قطاع السياحة، وتمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي. وقد شهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وهذا ما أكدته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، التي أشارت إلى أن أعداد السائحين الوافدين الى مصر ستصل إلى نفس معدل أقصى عدد تم تسجيله للسائحين الوافدين الى مصر والذي كان عام 2010، وأصبحت نسبة حجز الفنادق في مصر هذا العام هي الأعلى منذ عام 2011، وهذا يعزى الى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام وعودة رحلات الطيران البريطانية والروسية المباشرة، وقرب افتتاح منشآت سياحية جديدة على رأسها المتحف المصري الكبير. وقد تجاوز صافي إيرادات مصر من هذا القطاع 12.5 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019 وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية. بطبيعة الحال تأثر هذا القطاع خلال العامين الأخيرين بفعل تداعيات جائحة “كورونا”، لكن كان ثبات الاقتصاد المصري وعدم تراجعه – رغم أن السياحة تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي المصري – أثبت أن الإصلاح الاقتصادي ساهم بشكل فعال في حماية جانب مهم من جوانب القوة الشاملة المصرية، وهي الاقتصاد.
قناة السويس تمثل أيضاً مصدراً مهماً للدخل القومي المصري، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2016، تطورت قدرتها على استقبال أعداد أكبر من السفن في الاتجاهين، وهو ما ساهم في زيادة مطردة في إيراداتها. حيث سجلت في عام 2017 5.3 مليار دولار، وفي عام 2018 سجلت 5.9 مليار دولار، فيما تستهدف خطة التنمية للعام 2019/2020 مواصلة تنامى الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار. وقد تزايد إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن، مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن فى عام 2019/2020، وكذلك تزايدت أعداد السفن المارة بالقناة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019، ومن المخطط له ان تصل إلى نحو 18.2 ألف سفينة فى عام الخطة 2019/2020. ولتحقيق معدلات النمو المستهدفة لقناة السويس، تشرع هيئة القناة في خطة لضخ استثمارات عام 2019/2020 تصل إلى 9.6 مليار جنيه، تضاف الى قيمة المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في المنطقة الاقتصادية للقناة، والتي تبلغ 25 مليار دولار، وتستهدف الهيئة خلال العقد المقبل تنفيذ مشروعات اضافية بقيمة 55 مليار دولار لتوفير نحو مليون فرصة عمل.
قطاع الطاقة .. أحد أبرز ركائز الجانب الاقتصادي من القوة الشاملة
شهدت مصر خلال السنوات الماضية توسعاً كبيراً في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة كفاءة الموجود منها بالفعل، وهو ما أدى إلى انتهاء مشكلة الطاقة الكهربائية في مصر تماماً، وتوفر فائض للتصدير، وهو نفس ما حدث في ما يتعلق بالمواد البترولية التي انتهت تماماً ازمة شح توفرها، بعد ان انتظم العمل في مرافق الاستخراج والتصنيع. اما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد كان القطاع الأبرز من قطاعات الطاقة التي شهدت نمو خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ 31 مشروعًا غازياً باستثمارات تبلغ 21.4 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز، لتتمكن مصر أواخر العام الماضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبدأها في عمليات التصدير. وبحسب تصريحات وزارة البترول، فإنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022. ولعل من أهم الحقول التي تم اكتشافها في هذه الفترة هو حقل “ظٌهر” الغازي في البحر المتوسط، والذي تم الاستثمار فيه بمبلغ 15.6 مليار دولار، ويضاف اليه حقول واكتشافات أخرى مثل حقل “نورس”، الذي سيضيف إلى الإنتاج المصري نحو 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بتكلفة تصل الى 290 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، والذي يهدف إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات، والتي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول رئيسية. ومنطقة غرب الدلتا هي من المناطق الواعدة على مستوى الاحتياطيات المكتشفة من الغاز، ففي المرحلة التاسعة من العمليات في هذه المنطقة تم إدخال بئرين الى الإنتاج الكامل في أواخر العام الماضي، يضاف إليهم تسعة آبار ضمن منطقة حقول دسوق. ويضاف هذا كله إلى مشروعات لمد خطوط للأنابيب سواء بين مصر وقبرص، أو حتى خطوط داخلية على الأراضي المصرية مثل مشروع خط أنابيب نيدوكو/الجميل، الذي يستهدف نقل 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقل نيدوكو إلى محطة المعالجة والإسالة في منطقة الجميل قرب مدينة بورسعيد.
يذكر أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها توجيه مجهود أكبر للاستفادة من الطاقة المتجددة، بهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، بجانب التوسع في استخدام الطاقة النووية مستقبلاً بعد إتمام إنشاء المفاعل النووي المصري في الضبعة. وكذا الدخول بشكل أكبر في مجال استغلال الطاقة الشمسية، بعد افتتاح مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية في مدينة أسوان، بقدرة توليد تصل الى 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وأكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، ويضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، بإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
استغلال مصر للطاقة المتجددة لم يتوقف فقط على الطاقة الشمسية، بل شمل أيضا الطاقة الكهرومائية وطاقة الفحم النظيف والرياح، وقد وقعت مصر عقوداً مع الصين بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار لإنشاء محطتين الأولى هي الأكبر من نوعها لاستغلال الفحم النظيف، بقدرة تصل الى نحو 6000 ميجاوات في منطقة الحمراوين جنوبي مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة 4,4 مليار دولار، وتتضمن هذه المحطة ميناء لاستقبال الفحم. أما المحطة الثانية فهي لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة تبلغ نحو 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تصل الى 2,6 مليار دولار.
وافتتحت مصر عام 2018 إحدى أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، وتشمل هذه المحطة المكونة من ثلاثة أقسام 390 توربينًا لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح على مساحة 100 كلم، بقدرة تصل إلى 580 ميجاواط، وقد تم بالفعل ربط جزء من هذه التوربينات بشبكة الكهرباء القومية الموحدة. حالياً يصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن إلى نحو 3.9 جيجا وات من الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح، وتشير التقديرات الى أن القدرات الكهربائية الإجمالية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر تصل إلى 90 جيجاوات، نظراً لتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن أجل تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، تم أواخر عام 2014 تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والذي يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة.
هذا القطاع ينتظره مستقبل واعد جداً، سيساهم في نمو مطرد للصناعة ولقطاع الطاقة في مصر، فحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، حول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر، فإن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، وتستطيع هذه المصادر أن تحقق توفير في تكاليف التشغيل والطاقة قدرها 900 مليون دولار سنويًا.
الاستقرار الداخلي .. يلقي بظلاله على الأداء السياسي المصري إقليمياً ودولياً
تمكنت القيادة المصرية خلال السنوات الماضية من عبور العديد من العقبات الأمنية والعسكرية والاقتصادية على المستوى الداخلي، ونجحت في اجتياز عائق التدهور الأمني والاقتصادي، وباتت الدائرة الأن معكوسة في الاتجاه الإيجابي، وهو ما أنعكس على التعاطي السياسي المصري مع القضايا الخارجية، فقد ظنت بعض القوى الإقليمية أن القاهرة ستركن إلى همومها الداخلية، وستترك المحيط الإقليمي مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية بمختلف أنواعها، لكن النجاح المصري في الداخل، ساهم بشكل أساسي في جعل هذه القوى تلجأ إلى القاهرة، طلباً للمساعدة تارة، وطلباً لتحسين العلاقات تارة أخرى.
البعد العربي في النظرة المصرية للإقليم كان أساسياً، وظهرت فيه ملامح أعادت للذاكرة ملامح القومية العربية، فبدأت مصر بتطوير وتحسين علاقاتها مع البوابة الشرقية للأمة العربية – العراق – وباتت القاهرة مع بغداد وعمان، محور نموذجي للتكامل العربي، يحتذى به في قادم السنوات، وهو هدف مصري معلن، تستهدف من خلاله القاهرة تعزيز التضامن العربي، ونبذ الخلافات، وإعطاء فرصة للدول العربية “ذات الحسابات الضيقة” كي تعود عن نهجها. هذا التكامل شهدته العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكانت مصر صاحبة صبر استراتيجي طويل في ما يتعلق بعلاقاتها مع دولة قطر، التي تحاول الآن تحسين علاقاتها مع مصر، بعد سنوات راهنت فيها الدوحة على عدم استمرار القاهرة في مسارها الذي بدأتها في الثلاثين من يونيو 2013.
اليد المصرية الداعمة والمساندة امتدت في كافة أرجاء الإقليم، فكانت وسيطاً بالمشاركة مع روسيا بين المكونات الكردية في الشرق السوري والحكومة السورية، وداعمة على المستوى الاقتصادي لكل من العراق والأردن، وتدخلت بشكل حاسم في الملف الليبي حين وجدت ان الارهاب بات على مشارف حدودها الغربية، ففرضت الخط الأحمر الشهير – ليس بهدف العدوان او التهديد – بل بهدف وقف حرب داخلية أتاحت لأطراف إقليمية منها تركيا التدخل بشكل غير بناء في ملف عربي محض، وقد كانت التطورات اللاحقة في هذا الملف دليلاً واضحاً على حسن إدارة القاهرة لهذه الأزمة، بداية بالنجاح في إيقاف الحرب، مروراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد، وصولاً إلى تزايد الدور المصري في الغرب الليبي على كافة المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية، وهو نجاح كان – بجانب الأداء المصري في ملف شرق المتوسط – سبباً في إجبار أنقرة على السعي لتحسين علاقاتها مع القاهرة، بعد أن وجدت أن الإرادة المصرية هي الغالبة.
أفريقيا كانت مثال آخر من أمثلة تعاظم التأثير المصري الخارجي، وليس أدل على ذلك من سلسلة الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي وقعتها القاهرة مؤخراً مع طائفة واسعة من دول شرق وجنوب شرق أفريقيا، والزيارات المتتالية للمسئولين المصريين إلى دول أفريقية – بعضها لم يزره أي مسؤول مصري منذ عقود – وهي ملامح إذا أضفنا إليها تعاظم الدور الاقتصادي المصري عبر الشركات العاملة في الدول الأفريقية، وعبر المساعدات الطبية والعينية التي ترسلها القاهرة بشكل دوري إلى هذه الدول، كلها تؤكد ليس فقط عودة مصر إلى أفريقيا، بل تصدرها المشهد الأفريقي بشكل كامل.
الملف العربي الأبرز، وهو ملف فلسطين، كان أخر الدلائل على تعاظم القوة المصرية الشاملة، فمصر واكبت منذ اللحظة الأولى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تسمح باستمراره، وساهمت بشكل أساسي في الحيلولة دون شن تل أبيب لهجوم بري على القطاع، وتمكنت من فرض وقف نموذجي لإطلاق النار. الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد كما درجت العادة في ما يتعلق بجهود الوساطة في نزاعات مماثلة، بل اعلنت القاهرة عن مبلغ قياسي لدعم إعادة إعمار قطاع غزة – نصف مليار دولار – أعقبته بعد أيام بإرسال عشرات الآليات الفنية والمهندسين المصريين، للبدء في أعمار القطاع، بالتزامن مع التجهيز لاجتماعات قريبة في القاهرة برعاية مصرية لكافة الفصائل الفلسطينية، لبحث كافة القضايا العالقة، في مشهد نموذجي تبدو فيه القاهرة ممسكة بكافة جوانب القضية الفلسطينية، في مهارة تعيد للذاكرة حقبة الستينيات، التي كانت فيها مصر هي اللاعب الأول والأوحد في الشرق الأوسط.
باحث أول بالمرصد المصري





