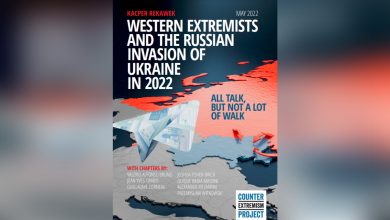مستقبل الرأسمالية .. عدد جديد لمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية
بعد تراجع الأيديولوجيات المنافسة، ظهرت العيوب الخاصة للرأسمالية بعد أن كانت ناجحة كنظام للاقتصاد السياسي سيطر على العالم في القرن العشرين، وأيضًا برزت المطالبات بضرورة إيجاد شيء جديد أفضل. في الإصدار الجديد من مجلة فورين أفيرز (شهري يناير وفبراير 2020)، يتحدث الجزء الخاص بمراجعة الليبرالية تحت عنوان “مستقبل الرأسمالية” الذي شارك فيه عدد من الكتّاب عن تصارع معسكرين من الرأسمالية أحدهما يقوده الليبراليات الصناعية المتقدمة، والآخر تقوده الصين. ومن المشكلات التي طُرحت أيضًا كانت أنه لم يستطع أحد إيجاد صيغة موثوق بها للنجاح الاقتصادي، والعودة للحديث عن دور للحكومات في التدخل لتحسين حياة الشعوب بعد أن تلاعبت النخب بالنظام لحماية مصالحهم الخاصة وتجويع الدولة وتركيز الثروة والركود، بما يعني أن الرأسمالية قد بلغت أقصى حدودها، وبات هناك من يبحث عن تكييف المُثل الاشتراكية التقليدية مع الحقائق المعاصرة، بما يؤدي لتمكين الناس والمجتمعات بدلاً من الدولة.
ففي الجزء الخاص بالجانب النظري الذي تناولته المجلة عن مستقبل الرأسمالية؛ عدد من المقالات التي عرضت الفكرة من أكثر من زاوية على النحو التالي:
أظهرت مقالة المُعنونة بـ “صراع الرأسمالية: السجال الحقيقي من أجل مستقبل الاقتصاد العالمي”، وجهات النظر التي ترى كما لو أن النظام الاقتصادي الحالي على وشك الاختفاء، وأن الرأسمالية تواجه تهديدًا متجددًا من الاشتراكية. لكن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الرأسمالية ستبقى ولن يكون لها منافس لأن بدونها ستنخفض الدخول ويزيد الفقر ويتباطأ التقدم التكنولوجي. هناك نموذج من الرأسمالية تقوده الصين ويحاول ضمان الفرصة للجميع، لكنه يوفر طرقًا مختلفة تمامًا عن النموذج الأمريكي لهيكلة القوة السياسية والاقتصادية في المجتمع.
من التحديات التي تواجه بقاء الرأسمالية على المدى الطويل، ظهور طبقة عليا مستقلة في ظل تزايد عدم المساواة وتعثر بيروقراطية الدولة. يضاف إلى هذا ضرورة قيام الحكومات بتحقيق نمو اقتصادي باستمرار لإضفاء الشرعية على حكمهم. من جانب آخر، فإن اعتبار الصين كانت الدولة الأكثر نجاحًا اقتصاديًا في نصف القرن الماضي تضعها في وضع يمكنها من محاولة تصدير مؤسساتها الاقتصادية والسياسية بصورة مشروعة، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق. لذا تحتاج الرأسمالية السياسية إلى الترويج لنفسها على أساس توفير إدارة مجتمعية أفضل، ومعدلات نمو أعلى.
واختتمت المقالة بأنه من غير المؤكد أن تحافظ الصين على حكم الطبقة المتوسطة في ظل محدودية الطبقات فيها، لأنه سبق فشله في الجزء الأول من القرن العشرين في ظل جمهورية الصين حتى 1949، وسيكون من الصعب إعادة اختباره.
وأشارت مقالة ُمعنونة بـ “كيف ينتهي الفقر؟ العديد من مسارات التقدم- ولماذا لا تستمر”، أنه رغم قلة معدلات الفقر وتحسين نوعية الحياة، تظل المكونات الحقيقية للنمو الاقتصادي المستمر غامضة، فلا يمكن التنبؤ بسبب توسع بعض الاقتصادات وعدم قيام البعض الآخر بذلك، وتغير معدلات النمو في البلد نفسه تغيراً جذرياً من عقد إلى عقد. مما يجعل الرهانات قائمة على محاولة الدولة رفع مستويات المعيشة بالموارد التي تملكها الدولة بالفعل. وذلك على اعتبار أن الوضع الذي يمكنه تحسين النمو هو رفاهية الفقراء.
فيما اوضحت مقالة أخرى مُعنونة بـ “الدولة الجائعة: لماذا يعتمد خلاص الرأسمالية على الضرائب؟” إلى أن ازدهار الأسواق لم يتم دون مساعدة الدولة والدعم الحكومي لتوفير السلع العامة وتصحيح إخفاقات السوق، بمعنى أنه لا يمكن لأي سوق ناجح البقاء على قيد الحياة دون دعائم دولة قوية وعاملة لضمان الأمن وتوحيد المقاييس والعملات وبناء البنية التحتية والحفاظ عليها ومحاكمة الجهات الفاعلة السيئة التي تحقق ثروتها من خلال استغلال الآخرين بطريقة أو بأخرى، وأن السماح للدول بتحصيل نصيبها العادل من الإيرادات في شكل ضرائب لن يفضي إلى حقبة عصيبة من الحكم القمعي، لأن تقوية الدولة سيعيد الرأسمالية نحو مستقبل تعمل فيه الأسواق في مصلحة مجتمعاتها.
وأشارت مقالة أخرى بعنوان “انهيار النيوليبرالية.. الأسواق ليست هي الحل”، إلى أن الرأسمالية التي هيمنت على المجتمعات خلال الأربعين عامًا الماضية تواجه أزمة من حيث تراجع الإيمان بالأسواق الحرة، وإلغاء القيود خاصة في أعقاب الأزمة المالية في 2007- 2008، وتعد المملكة المتحدة حالة على هذه الأزمة، والحاجة إلى إقامة عقد اجتماعي جديد بين الدولة لخلق أجند اقتصادية جديدة تختلف عن الاشتراكية التقليدية، وربما يكون إقليم الباسك في إسبانيا مثالًا على ذلك قائمًا على التحرك من أسفل لأعلى. واعتبر المقالة أن هذا التفكير الجديد سيستغرق بعض الوقت لإنتاج التغييرات اللازمة.
وفي مقالة بعنوان بـ وهم الاشتراكية الجديدة: الثروة ليست المشكلة، تمت الإشارة إلى مساعي مجموعة من السياسيين اليساريين مثل جيريمي كوربين لتحدي الرأسمالية ومحاولة إحياء أيديولوجيا جديدة تستهدف تحقيق أكبر قدر من المساواة. ويرى التقرير أن الانتقادات المستمرة للرأسمالية ساعدتها في الإصلاح، لكن إذا تم تطبيق الاشتراكية الجديدة على أنها إصلاح للرأسمالية ستكون النتائج كارثية لأنها غير مهتمة بالحفاظ على القطاع الخاص وريادة الأعمال.
طرح العدد الجديد من المجلة مجموعة من المقالات التي تناولت عدد من التحولات المتلاحقة على الصعيد الدولي والإقليمي؛ حيث ذهبت مجموعة من الكتابات للحديث عن الصعود الصين، وإعادة هيكلة النظام العالمي لمواجهة التحديات المتتالية، فضلاً عن التطرق إلى مآلات التهديدات غير التقليدية مثل تغير المناخ.
ركزت المقالة الأولى المُعنونة بـ “الخوف من الصين الجديد؛ لماذا لا ينبغي على أميركا الخوف حيال التحدي الأخير”، على النقاش الدائر داخل الأوساط الأمريكية الرسمية التي تؤكد على أن الصين أصبحت تهديدًا حيويًا واقتصاديًا واستراتيجيًا لواشنطن؛ إذ استخدمت بكين الاقتصاد الدولي لدعم نظامها، كما أصبحت السياسة الخارجية لها أكثر طموحًا وحزمًا، من سعيها لأداء أدوار قيادية في وكالات الأمم المتحدة إلى لعب أدوار أوسع من خلال مبادرة الحزام والطرق وبناء الجزر في الجنوب بحر الصين.
ولفتت المقالة أن التحدي الذي يواجه واشنطن والغرب هو التكيف واستيعاب الطموح الصيني، الذي أصبح هزيمة للنظام الليبرالي ومجموعة السياسات والمؤسسات، التي صاغتها إلى حد كبير الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، التي تشكل نظامًا يستند إلى قواعد تراجعت فيه الحرب بين الدول. وعليه فقد أوضحت المقالة ضرورة مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه بكين من خلال تشجيعها لممارسة نفوذ أكبر في منطقتها وخارجها طالما أنها تستخدم هذا النفوذ لتعزيز النظام الدولي، علاوة على دعم مشاركتها في الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، والانتشار النووي وغسل الأموال والإرهاب. وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق فيمكن الاستفادة منها من خلال متابعتها بطريقة منفتحة وشفافة، حتى بالتعاون مع الدول الغربية كلما أمكن ذلك.
وأوضحت المقالة المُعنونة بـ “من القيود إلى العولمة؛ لماذا حان وقت الانفصال؟”، أن العولمة أثبتت أنها ليست قوة من أجل التحرير ولكنها مصدر جديد للضعف والمنافسة والسيطرة، بالرغم من أن الكثير من
الكتابات كانت تؤكد على أن العولمة هي امتداد طبيعي لحريات السوق، إلا إنها سمحت بنوع جديد من الصراع بالتزامن مع توسع الشبكات الاقتصادية والمعلوماتية في العالم، وتجمع العديد منها حول نقاط تحكم واحدة، وظفته بعض الدول لتحقيق مصالحها الخاصة. ويرجع ذلك لأن النظام العالمي بعد الحرب الباردة اعتمد على الشبكات الرقمية والتدفقات المالية وسلاسل التوريد الممتدة في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع قيام بعض الدول مثل الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام لصالحها ففي خدمة حربها التجارية مع الصين، قامت بتقييد الشركات الضخمة والاقتصادات الوطنية بأكملها من خلال استهداف نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية.
فينا تناولت المقالة المعنونة بـ “المياه الضحلة في أوكرانيا حيث تصطدم الأوهام الأميركية وسياسة القوة العظمى“، المكانة الدولية لأوكرانيا في التفاعلات بين القوى الدولية الكبرى في الآونة الأخيرة، علاوة على جهود إدارة ترامب لربط المساعدات الأمنية الأميركية للبلاد بالتعاون الأوكراني في التحقيق مع خصوم الرئيس ترامب من الديمقراطيين. وتذهب التداعيات إلى أبعد من ذلك. فبالنسبة لمعظم صانعي السياسة الأميركيين، مثلت أوكرانيا دولة شجاعة، نجحت في إطلاق نفسها على طريق التطور الديمقراطي كجزء من نظام عالمي جديد بعد سقوط جدار برلين. بالنسبة للكرملين، في الوقت نفسه، تعد مجال نفوذ قوي لهم.
لذا فإن أفضل خيار لواشنطن في هذه المرحلة هو تعزيز علاقاتها السياسية والأمنية الثنائية مع أوكرانيا مع العمل عن كثب مع حلفائها الأوروبيين لضمان قدرة أوكرانيا على الحماية سيادتها من التدخل الروسي. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك، ينبغي على ترامب التوقف عن ممارسة الألعاب بمساعدة ووعد أوكرانيا؛ يجب عليه إعطاء الأولوية للمساعدة الأمنية والمشاركة الدبلوماسية على أساس مخصص التعامل.
تتناول المقالة المُعنونة بـ “التكيف أو الهلاك: التأهب لمآلات التغير المناخي ” النقاش العام حول التغيرات المناخية التي أصبحت مصدر قلق لصانعي السياسة في العالم، وتداعياتها على الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي، وصحة الإنسان. وعليه فقد أكدت المقالة على أهمية قيام الولايات المتحدة بإصلاح أنظمة التحكم الخاصة بالبنية التحتية، واستخدام البيانات المناخية والتمويل لمواجهة هذه التحديات المتنامية.
بجانب التطرق إلى دور القطاع العام والخاص في مجابهة العواقب، إلا إنهم غير مستعدين لأن التخصصات الأكاديمية والهيئات الحكومية غالباً ما تظل معزولة عن بعضها البعض، اما القطاع الخاص سيتطلب مستويات كبيرة من المرونة غير مسبوقة للتعاون. فعلى سبيل المثال، سيتعين على مسؤولي الصحة العامة إقامة شراكة مع محللي الجغرافيا المكانية وعلماء الأحياء لتوقع كيف يمكن لتغير المناخ أن يغير الانتشار الجغرافي لأمراض البعوض، مثل حمى الضنك وزيكا. وسيحتاج مديرو مخاطر الشركات إلى العمل مع المهندسين لمعرفة كيفية حماية المنشآت الصناعية من الظروف الجوية الجديدة المتطرفة. سيتعين على المخططين العسكريين أن يتعلموا من مصممي المناخ كيفية تأمين القواعد وسلاسل الإمداد.
تشير المقالة المعنونة بـ “عصر تنافس القوى العظمى: كيف قامت إدارة ترامب بإعادة صياغة الاستراتيجية الأميركية“؛ إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذ تستعد لعصر جديد – عصر لا يتميز بهيمنتها بمفردها بل بوجود عدد من الدول مثل الصين وروسيا التي تسعى لتقويض القيادة الأميركية، وإعادة تشكيل السياسة العالمية لصالحها. في المقابل قطعت إدارة “دونالد ترامب” خطوة مهمة إلى الأمام؛ حيث تواجه واشنطن منافسين أقوى وأكثر طموحًا من أي وقت في التاريخ الحديث.
ومن المرجح أن تصبح الصين – التي تسعى إلى الهيمنة في منطقة المحيط الهادئ الأولى والأولوية العالمية بعد ذلك – أقوى منافس واجهته الولايات المتحدة في تاريخها. وقد تكون روسيا أقل من كونها منافسًا نظيرًا، لكنها أثبتت قدرتها على إسقاط القوة بطرق لم تكن متوقعة في ختام الحرب الباردة. واليوم، تعتزم إحياء صعودها في أجزاء من أوروبا الشرقية التي كانت ذات يوم تقع في دائرة نفوذها وتأمل في تسريع نهاية التفوق الغربي في العالم بأسره. كما تكمن إمكاناتها التخريبية جزئياً في قدرتها، من خلال تحركات المصلحة الذاتية، على إحداث أزمات شاملة ستفيد القوة الصينية على المدى الطويل.
وفي الشق الخاص بالعروض النقدية لكتب ومقالات، أثارت بعض الموضوعات التي تجلت في:
- النخب الجديدة وعدم المساواة، إذ أن تزايد حالات عدم المساواة وتوقف نمو الطبقة الوسطى، مما أدى لظهور اقتراحات مثل إجراء تغييرات في ضريبة الرواتب وإعادة توزيع العمل بطرق تدعم “الإنتاج من ذوي المهارات المتوسطة”، بالإضافة لتحسين التدريس ومعدلات إتمام الدراسة الجامعية، ومن ثم زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
- أحلام ويستفاليا: هل يمكن لصفقة كبرى حل مشاكل الشرق الأوسط؟، فقد يتم ذكر عام 2019 كنقطة انعطاف في الشرق الأوسط، بعد تدهور الثقة في الولايات المتحدة بقدرتها على حل المشكلات في ظل العنف وعدم الاستقرار. وتراجع الثقة في الولايات المتحدة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، خاصةً مع توجه ترامب لسحب القوات من المنطقة، وتأكيد ذلك من مرشحي الرئاسة الأمريكية من الديمقراطيين في 2020 أيضًا. بالإضافة للحديث عن عقد “صفقة أوسع نطاقًا” تسعى إلى معالجة جميع النزاعات بالمنطقة استنادًا للصراع الغربي في حروب الثلاثين عامًا، وعقد مؤتمر سلام يشارك فيه جميع الخصوم حتى مع استمرار القتال. اعتبار أن الحل النهائي للعنف الذي يعصف بالشرق الأوسط سيتطلب الاهتمام بمصادر الصراع الداخلية والممارسة الداخلية للسلطة، بدون هذا الجهد وبدون الإرادة السياسية للسلام بين أي من اللاعبين الرئيسيين، من المرجح أن تستمر الحروب الطويلة في الشرق الأوسط.
- الأموال المشبوهة. كيف يشكل الفساد العالم؟ في ظل قلة الدول التي ترغب في محاكمة جريمة الفساد، هناك القليل من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في هذه الجهود. فالفساد يشبه السرطان ويحول الموارد من الفقراء للأغنياء ويشوه النفقات العامة ويثبط المستثمرين الأجانب، لكن لم يعد مقبولًا محاكمة الفساد لأسباب تتعلق بالنفعية الجيوسياسية، فكل من يكتب عن الفساد يجد أن تشخيص المرض أسهل من وصف العلاج. ينتج هذا جزئيًا عن قلة المعرفة بالأبعاد الدقيقة للفساد ويعكس أيضًا مدى صعوبة المشكلة، ولم تخصص الحكومات والجامعات ومراكز البحوث المزيد من الموارد لإجراء البحوث الأساسية، ناهيك عن أن الكثير من الأبحاث حول الفساد مضللة، وعدم مواجهة الفساد يعني ظهور نوع من الاستبداد المتصاعد وسيصبح هو القاعدة العالمية، لذا فإن مواجهته يحمل مصلحة في الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية.
- دوام الاتحاد… ماذا حدث للفكرة الأوروبية؟ ربما يكون الاتحاد الأوروبي التجربة الأكثر طموحًا ونجاحًا في التعاون الدولي التطوعي في التاريخ، لكنه بات مملًا. يتفق المفكرون على أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استبدال الدول القومية، لكن هناك فرق تعارض ذلك وفرق مؤيدة. خففت جميع الأحزاب السياسية اليمينية تقريبًا من انتقاداتها للاتحاد الأوروبي. قد لا يسعى قادة الأحزاب اليمينية إلى إجراء استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت لم يقترح اليسار تصوراً متماسكاً أو مشروعاً لمستقبل أوروبا. يحتاج الأوروبيون إلى رؤية تقدر فضائل السياسات السليمة والواقعية.
- دروس ما بعد الحرب لليساريين، يثير ظهور سياسات غير ليبرالية حول العالم قلقًا بشأن مستقبل النظام الليبرالي الدولي ومصير المؤسسات الدولية التي أنشأتها واشنطن وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام والانفتاح الاقتصادي، فقد يؤدي تضاؤل الشعوبية الجديدة وعدم قدرتها على الحكم إلى توحيد اليسار إلى حد لم يكن ممكنًا قبل صعودهم.
- مسارات القوة: صعود وهبوط الدكتاتور، فالعالم في مرحلة غير ليبرالية في ظل تعزيز الديكتاتوريون قبضتهم. يفرض صعود قادة وحركات استبدادية في العديد من الديمقراطيات أهمية فهم الحكم الديكتاتوري. لدى قليل من الدكتاتوريين استراتيجية واضحة وليس لديهم خطط تفصيلية حول كيفية ممارسة السلطة، وتظهر الديكتاتوريات عندما تدعم القوى الأجنبية حاكمًا غير منتخب أو عندما تغير الأحزاب المنتخبة القواعد لمنع إجراء مزيد من الانتخابات الحرة، أو ما يسمى استبداد. بمجرد وصوله إلى السلطة، يجب على الديكتاتور ودائرته الداخلية أن يوازنوا بين التعاون والصراع. يتمثل أحد الدروس الرئيسية من عمل الديكتاتوريات في أن المستبد الطموح سيعمل على إنشاء حزب سياسي مهيمن، وخلق نوع من التبعية الشعبية للحزب. يجب العمل على فهم الأنماط غير الرسمية المتسببة في التآكل الديمقراطي.
اتجاهات عالمية
عرض العدد الجديد مجموعة من الكتب التي تم إصدارها خلا عام 2019 التي تعبر عن الاتجاهات العالمية، وأهم الأفكار المُثارة في التفاعلات الدولية التي تتجسد أبرزها على النحو التالي:
- الممر الضيق: الدول والمجتمعات ومصير الحرية بقلم دارون أكيموغلو وجيمس روبنسون، يجادل الكتاب أن العديد من الدول لم تتمكن من إنتاج مجتمعات حرة. لذا يتعين عليها أن تسير على خط رفيع لتحقيق الحرية، مروراً بما يصفه المؤلفون بأنه “ممر ضيق”. لتشجيع الحرية، كما يجب أن تكون الدول قوية بما يكفي لفرض القوانين وتوفير الخدمات العامة ولكن أيضًا مقيدة في تصرفاتها وفحصها بواسطة مجتمع مدني جيد التنظيم. ويطلق المؤلفون على تلك الدول التي تسير على هذا المسار “حُرُس الأشرار”، وهي حكومات مكرسة لدعم حكم القانون، وحماية الضعيف ضد الأقوياء، وتهيئة الظروف لإتاحة الفرصة الاقتصادية لأكبر عدد من الأفراد داخل المجتمع.
- التنمية العالمية: تاريخ الحرب الباردة بقلم: سارة لورينزي؛ أوضحت الكاتبة أن تاريخ التنمية يعود إلى الغرب خلال الثورة الصناعية وأصبحت واجهة في المعركة الإيديولوجية للحرب الباردة، حيث تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على قلوب وعقول المجتمعات في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. على الرغم من أن صياغة “الحريات الأربع” التي وضعها الرئيس الأميركي “فرانكلين روزفلت” مهدت الطريق لنهج أمريكي متميز، فإن إدارة ترومان لعبت دورًا محوريًا في تحويل المساعدة الإنمائية إلى أداة للأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية.
- السلام العالمي (وكيف يمكننا تحقيقه) بقلم أليكس ج. بيلامي؛ يجادل الكاتب بأن الحركة من أجل السلام العالمي ليست مشروعًا خياليًا واسع النطاق بل إنها واقع عملي يعتمد على تاريخ طويل من الانتصارات الصغيرة. على الرغم من أن الحروب الدينية والعرقية تتصاعد، إلا أن الكاتب كان أكثر تفاؤلاً بشأن الاتجاه التاريخي بعيدًا عن الصراع. فقد امتنعت القوى العظمى عن الحرب مع بعضها البعض لأطول فترة في العصر الحديث، ووضعت الأمم المتحدة قواعد ومؤسسات للتسوية السلمية للمنازعات وحفظ السلام وحماية المدنيين، واستخدام القوة لغزو الأراضي قد فقد شرعيته كأداة للحكم. وفي الوقت نفسه لن تُلغى الحرب أبدًا، لكن لدى البشر القدرة على التعلم والتأقلم والوصول إلى أسس أخلاقية عالية. من خلال خطوات عملية وتدريجية مثل وضع قيود قانونية على إدارة الحرب، وبناء المؤسسات للوساطة في النزاعات، والتعاون في صنع السلام بعد الحرب، تعزيز قواعد الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وحماية النساء والأطفال في مناطق الحرب.
- النظام الدولي: تاريخ سياسي بقلم ستيفن أ. لين رينر؛ أكد الكاتب أن صعود الصين، الصراعات المتلاحقة في النظام الدولي ساهمت في تجديد النقاش العام حول طبيعة النظام الدولي وما بعد الولايات المتحدة. الذي تبلور نتيجة إرادة القوى الدولية التي أرادت وضع قواعد ومؤسسات تتناسب مع مصالحها الخاصة. فقد كانت النتيجة توازن غير مستقر من الإكراه والموافقة، الذي أصبح في نهاية المطاف مصدرا للاضطراب. فـ”النظام الليبرالي” الحالي يقوم على المؤسسات المتعددة الأطراف وتعزيز حقوق الإنسان والدبلوماسية القوية والتدخل العسكري.
- تمكين الانتقال الكبير للطاقة: سياسة مستقبلية منخفضة الكربون بقلم فيكتور سكوت ، مارلين أ. براون، وبنجامين ك. سوفاكول؛ يدرس هذا المسح العلاقة بين استخدام الطاقة العالمي وتغير المناخ والتطورات التكنولوجية، ومصادر الطاقة البديلة ويتتبع كيف استجابت الحكومات والمجتمعات – أو لم تستجب – لأزمة المناخ. يرسم المؤلفون الطرق التي يمكن أن يحفظ بها الناس الطاقة من خلال تغييرات متواضعة فقط في سلوكهم، وكيف يمكن للقادة والمجتمعات المحلية أن يلعبوا دورًا كبيرًا في جعل الانتقال الحتمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
- تكاليف الحوار: عقبات أمام محادثات السلام في زمن الحرب بقلم أوريانا سكايلار ماسترو؛ إذ يطرح ماسترو عدد من التساؤلات حول العقبات التي تمنع التوصل إلى سلام في مراحله ما بعد الصراع، موضحًا لماذا يمكن أن يكون من الصعب للغاية على المحاربين إيجاد طريق دبلوماسي للخروج من النزاع، كما أن البدا في احتضان محادثات السلام يمكن أن يشير إلى الضعف وقلة العزم، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس بشكل سلبي على المحاربين، وقوتهم المعنوية، بينما يشجع الخصم على التمادي في نهجه الصراعي.
- تاريخ قصير من خروج بريطانيا من تأليف كيفن أوروك؛ يبحث عن الدوافع الكامنة وراء التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحًا الحجج التي مفادها أنها كانت نتيجة حتمية للعوامل الاقتصادية الهيكلية، أو أنها نتجت عن رد فعل عنيف في غير محله ضد عدم المساواة المتزايد، أو أنه كان مجرد صدفة نتجت عن سوء التقدير السياسي والانتهازية. ومع ذلك، أصبح من الواضح أنه حتى المتشددين من الداعمين للخروج يدركون أنه ليس من المنطقي الاقتصادي أو السياسي إزالة التنسيق السياسي مع أوروبا. لا يكمن جوهر حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نقد اقتصادي بل في شعور بالاستثناء الثقافي والتاريخي البريطاني.
- كيف شكل قادة إسرائيل الأكثر أهمية مصيرها بواسطة دينيس روس ودايف ماكوفسكي؛ يقدم المؤلفان، كتابًا في جزأين. الأول يتكون من السيرة الذاتية لأربعة قادة إسرائيليين اتخذوا جميعًا قرارات مهمة تؤثر على علاقات إسرائيل مع خصومها العرب. فيما يتناول الجزء الثاني، الحجج المؤيدة والمعارضة للفكرة القائلة بأن إسرائيل مهددة بـ “قنبلة موقوتة” ديموغرافية عربية داخلية. ويعتقد المؤلفون أن نمو السكان الفلسطينيين هو نمو طويل الأمد. مصطلح تهديد للنظام الديمقراطي في إسرائيل. كما يقدمون اقتراحات حول ما يمكن أن تفعله إسرائيل من جانب واحد للتحرك نحو حل ثنائي – وكيف يمكن لواشنطن أن تدعم مثل هذه الأعمال. المؤلفون كان ينبغي أن يقضي المزيد من الوقت في هذه الخيارات السياسية وأقل على السير الذاتية.
- صعود متنامي: الحرس الثوري الإيراني والحروب في الشرق الأوسط بقلم نادر أوسكوي؛ تتناول الدراسة فيلق الحرس الثوري الإسلامي في إيران، الذي تأسس عام 1979 للدفاع عن الثورة الإسلامية في البلاد. في عام 1980؛ إذ أنشأت إيران قوة القدس، وهي مفرزة من الحرس الثوري تهدف إلى تعبئة المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. يركز أوسكوي على قوة القدس وقاسم سليماني، الذي قاد المجموعة منذ عام 1998.
- الوجوه الكثيرة لحركة الشباب بقلم ماري هاربر، يتناول الكتاب كيف استطاعت حركة شباب المجاهدين في الصومال التكيف والتأقلم على المتغيرات والانتكاسات التي تواجهها، كما يتطرق إلى القوة التنظيمية للحركة، واستخدامها الفعال لشبكات الاستخبارات، مع التركيز على الشباب وكيفية توظيفهم للقيام بأعمال إرهابية.